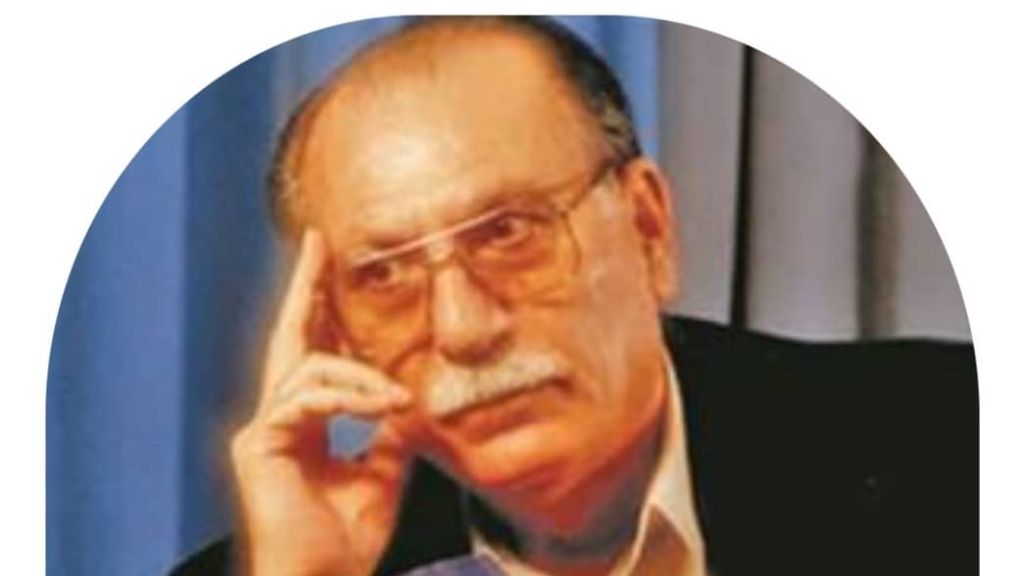في الثاني من شهر أيار الجاري مرّت الذكرى العاشرة لوفاة الناقد الفلسطيني الكبير يوسف سامي اليوسف، الذي وُلِد في قرية لوبية التابعة لـ طبرية في فلسطين سنة 1938م، ولجأ سنة 1948م سنة النكبة الفلسطينية إلى لبنان مع أسرته، ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا سنة 1956م واستقر في دمشق.
دخل جامعة دمشق عام 1960م في كلية الآداب – قسم اللغة الإنكليزية وتخرّج منها عام 1964م، مارس التدريس في مدارس الأونروا مدرساً للغة الإنكليزية قبل تخرّجه من الجامعة. عاش حياته في مخيّم اليرموك جنوب مدينة دمشق، وإثر انطلاق الثورة السورية عام 2011م هاجر إلى مخيّم نهر البارد في طرابلس – لبنان أواخر 2012م وبسبب كثرة أمراضه المزمنة واشتدادها عليه، شاءت إرادة الله أن تريحه، فانتقل إلى رحمته تعالى في الثاني من شهر أيار سنة 2013م بعد أن ترك إرثاً ثقافياً ونقدياً كبيراً، وبصمة متفرّدة في علم النقد الأدبي.
ولعلّنا في ذكرى وفاته العاشرة نستذكر رؤيته في الشعر وكيف يمكن أن يكون عظيماً، من خلال كتابه المعنون بـ (ما الشعر العظيم؟)، وكتاب (الشعر والحساسية)، وهما كتابان يتقاطعان في كون الكاتب حاول فيها أن يبحث عن الروح والإنساني الذي يهب الشعر عظمته وتساميه.
يعتقد الكاتب والناقد يوسف سامي اليوسف، أن حكم القيمة النقدي إنما ينبجس من مصدرين ينبوعين: الأول نبل الذائقة الوجدانية الخالصة، والثاني سعة اطلاع الناقد وجملة ثقافته النازعة إلى الموسوعية والشمولية. (ما الشعر العظيم) ص7.
وهو بهذا التصوّر أو التقعيد يرسم الخارطة التي يجب أن يمشي عليها الناقد الحاذق طويل المراس في وقوفه أمام النصوص الأدبية لدراستها وسبر أغوارها، بعد أن يكون قد تجرّد من توجهه الأيديولوجي وهو يقف أمام أي نص أدبي، فيصدر حكم القيمة عنه نقيّاً من شوائب ما يميل إليه الناقد من أفكار أيديولوجية مسبقة.
إلا أنه يعدّ المزاج العام للناقد ضرورياً في تقييمه للنص الأدبي، فناقد عاش في بحبوحة من الثراء والنعميات المادية وغير المادية، يختلف بالضرورة عن ناقد تؤسسه كارثة وطنية، أو أسرة عاشت في الفقر والإملاق حتى القرار.ص7، فهذا المزاج لا يملك الناقد أن يتنصّل منه في عمله النقدي باعتباره إنساناً من لحمٍ ودم، فهو يستطيع الوقوف بحيادية فيما يخص اختلاف الآخرين عنه في توجهاته الأيدولوجية، إلا أنه لا يستطيع التنصّل من مزاجه الذي نشأ عليه وأصبح جزءاً من تكوينه النفسي.
وعليه فإن هذه الذائقة التي جعلها يوسف سامي اليوسف أحد مصدرين ينبوعين لحكم القيمة النقدي، لا تنبجس من الخارج، من التجربة أو التعلّم، بل من مملكة الماوراء القبلية الاستسرارية، لما لها من قدرة على تأسيس مجمل الروح. (ما الشعر العظيم) ص8 .
وباعتبار أنّ كل فرد يشكّل سرّاً خاصاً به، فالناقد الأفضل بنظره هو ذلك الذي يستطيع الولوج إلى هذا السر والوصول إلى تحليل تفاصيله عند هذا الشاعر أو ذاك، وهذا لا يتأتى في هذا العصر المتورّم بكل خبيث ومنحط إلا لناقد صاحب مزاجٍ خاص يستطيع القبض على هذا الآن الجليل المهيب.
لكن ذلك لا يعني أن يوسف سامي اليوسف يدعو إلى نقد مزاجي يتسكع بين النصوص دون ضوابط، بل إنه يرى أنه من العسير الإتيان بتعليلات جوهرية لقيمة نص أدبي عظيم أو حقير، ناهيك بالقول الفصل والحجة الأصلية الحاسمة، إذا لم يكن يملك محوراً دراسياً واضح القسمات مزوّداً بشيء من النزعة المعيارة. (ما الشعر العظيم) ص10
فالمزاج عند الناقد حسب رؤيته يتدخّل لتطويع المقولات المنهجية التي تحاول التحكّم بهذا المحور دون أن تفرض عليه التصلّب الذي يعيق حركته الشمولية.
معايير الناقد
ولعلّ يوسف سامي اليوسف هو من النقّاد القلائل الذين جعلوا معيار القهر ومعيار الدنف إضافة إلى معيار هيف الروح أساس منهجهم في معالجتهم للنصوص والغوص في بحارها واصطياد لآلئها، وهذا ما يجعله يحكم على الناقد الذي يركن إلى هذه المعايير أنه لا يؤمن ببرودة المنطق، بل بتوهّج الحياة وتدفّقها اللذين لا يخضعان للمنطق إلا قليلاً. وأما الناقد الذي ينطلق من المعايير الشكلية، وهي سطحية بنظره، فهو فقير بالوهج الشعري، وغير وثيق الصلة بالفنون.
فيوسف سامي اليوسف في منهجه النقدي يتبنى مقولة “عمانوئيل كانت” الذي قال بمحدودية العقل ونسبيّته؛ لأنه لا يدرك إلا ما طاف وظهر على السطح، وهو لا يكاد يبين عن أية ماهية جوهرية، وبالتالي هناك حسب الصوفية مقابل هذا الظاهر باطن وعمق لا نبلغه إلا بالواردات المزاجية (الحدوس)، أو ما تسميه الصوفية باللطائف النعناعية الجوّانية.
وبهذا لا يكون النقد ضرباً من علوم الفيزياء والكيمياء المخبرية، بل هو تنقيبٌ عن اللطائف والحرارة والطاقة والوهج الروحي، وإذا استطاع النقد أن يغوص في نص أدبي عظيم ويستخرج هذه المعاني، فهو نقد عظيم بشكل موازٍ للنص العظيم، فإذا كان هناك نص عظيم، فهناك نقد عظيم.
فالناقد اليوسف ينظر إلى النص الشعري من خلال علاقته بالوجدان، فما صدر عنه أي الوجدان، فهو الشعر، وما عدا ذلك، ليس إلا خواءً لا قيمة له رغم أنه أحياناً يوهمك بظاهره، فثمّة بين أساليب الشعر الحديث أسلوب خلّب يتبدّى أحياناً على النّمط الخليلي وأحياناً على نمط التفعيلة ويتمتّع بقدرة هائلة على إيهام المتلقي بأنّه أسلوب فاتن أو عظيم مع أنّه لا يستحق أن يوصف إلا بكونه صنفاً من أصناف الخلاء الأنيق. فكثيراً ما يجيء ظاهر الشيء مخالفاً لباطنه، وكثيراً ما يستطيع الزائف أن يزوّر نفسه وأن يوهم الناس بأنّه الذّهب الإبريز. (الشعر والحساسية)ص29.
فالشعر العظيم عند اليوسف هو ذلك الذي يبلغ إلى سويداء القلب، ولئن لم يفعل ذلك، فإنه لن يزيد عن كونه لغواً سوف تلغيه الأيام، حتى وإن نال الكثير من الاستحسان والتصفيق. (الشعر والحساسية)ص43.
ولعلنا أخيراً نستطيع القول إن الناقد يوسف سامي اليوسف قد رسم لنفسه ولمن آمن برؤيته للشعر طريقاً واضحاً في معالجته ومعرفة العظيم منه من العادي الفارغ الذي لا رواء فيه، وحكم القيمة هذا مركز دائرته الوجدان الصادق، فالكاتب والشاعر الذي يستحق الرتبة الجليلة والمقام الأعلى في عالم الأدب هو ذاك الروح المطهّم الحساس القلق المتوتر المغترب الذي يعيش في الجحيم الجاحم بالضبط، وكل ما يصدر عنه هو من هذا الجحيم، فكيف لا يكون بعد ذلك أدباً وشعراً عظيماً؟!